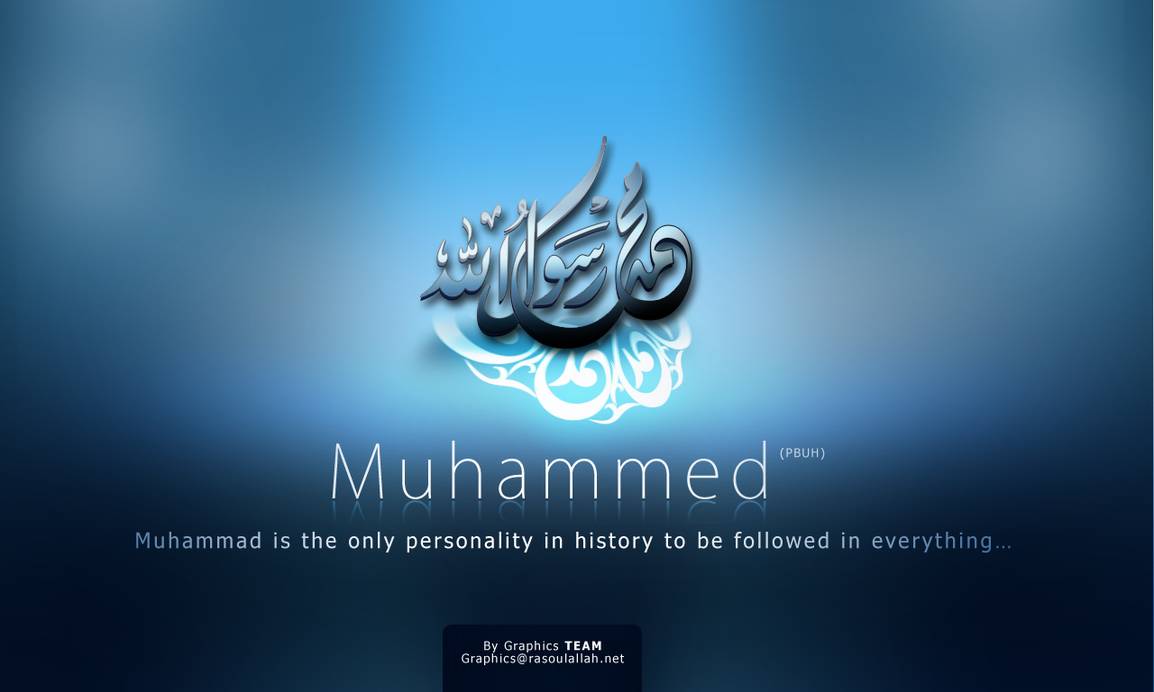حُمّى التناقض
2024-04-27

شادية الأتاسي
«قد لا ننتبه إلى الأشياء الصغيرة في حياتنا اليومية، أو مقدار الفرح والضوء الذي قد تمنحنا إياه بعض الكائنات اللطيفة». هكذا كتبت لي كاترين، صديقتي الكاتبة السويسرية في رسالتها – ضمن مشروعنا الرائع للتبادل الثقافي – وهي تحدثني مطولاً عن تاريخ طفولتها في قريتها الجبلية، مع الحيوانات الأليفة، خاصة القط الذي وصفته بالماكر والأناني لكنه مدلل ومحبوب.
حسنا يا صديقتي، هل أقول لك إن حديثك قد قذف بي فوراً في دوران مدهش، فتح شهيتي لموضوع ينبش في عقلي، وأطلّق في عقلي أسراباً من الأسئلة. لكن وقبل أن أمضي في هذه الأسئلة، أحب أن أروي لك حكاية لم يبهت وجعها بعد. حكايتي مع القطط.
في طفولتي، شغفني صياح ديكة الصباح الممطوط مع بزوغ الفجر، فتنتني زقزقة العصافير النزقة في تيهها الحر اللامتناهي، لكن القطط الصغيرة الشقية المغناج، بعيونها المرتخية على مكر لعوب، هو من أيقظ في داخلي هبوب مشاعر بنكهة دفء أنثوي مبكر. كنت ألاعبهم خلسة، وأحمل لهم الخبز والحليب، بعيداً عن عيني أمي التي تخاف وتكره القطط، العديد منها كان يلجأ إلى حديقة بيتنا خوفاً من تحرش الكلاب، أو هربا من أطفال صغار أو كبار، يجدون في اللهو بملاحقتهم وقذفهم بالحجارة، تسلية مريضة بأهواء لا مبالية.
تمردت على سطوة أمي، وتورطت بمغامرة، وأصبح لديّ قطة صغيرة. كانت واحدة من معاركي الصغيرة في الحياة، وقد فشلت بها بجدارة. ففي صباح نهار بارد وماطر، سمعت مواءً وخربشة ناعمة على باب بيتنا، فتحت الباب، رأيت قطة صغيرة، تنظر إليّ بعينين حزينتين، ترتجف بردا وجوعا، لم يكن بوسعي تركها، مددت لها يدي، قلت لها تعالي يا قطتي المسكينة، أنا وحيدة مثلك، نفختْ في وجهي بنفسْ خائر متردد، كانت خائفة، اقتربت منها وحملتها، قاومت قليلاً، ثم استكانت، ووقعت أنا بغرامها على الفور. أدخلتها خلسة إلى البيت، جلبت لها الماء والحليب والخبز، جففتها ودفأتها، صنعت لها بيتاً من كرتونة صغيرة في الحديقة، خبأتها تحت شجرة التين الضخمة، وفي ليالي البرد القارص، كنت أشفق عليها، فأدخلها سراً إلى فراشي. تنام في حضني، بعيدا عن عيون أمي، نغفو معا، وصوت خرخرتها يعزف موسيقى ناعمة في أذني.
أصبح لي سري الصغير، أيقظ في داخلي مشاعر حلوة، من متعة التواصل مع كائن بريء. لكن أمي اكتشفت الأمر. يا للهول! عقابي كان شديدا ومؤلما، لم تتسامح معي، ولم ترأف بدموعي. وضعها أبي في كيس أسود كبير، وذهب بها إلى مكان بعيد، وعاد دونها، عدت من المدرسة ولم أجدها، بكيت طويلا، وعزفت عن الطعام والشراب، ولذت بغرفتي، لكن القطة عادت بعد أيام، وجدتها تنتظرني على باب البيت عند عودتي من المدرسة، متسخة وجائعة ومرتجفة كما رأيتها أول مرة، كانت مريضة جدا، وما لبثت أن ماتت.
كانت لسعة ألم حارقة، رافقت نموّي وأنا أكبر، اقتلاعا مؤلماً للحب والرحمة. أصبحت أخاف الفقدْ، أخشى رحيل الأحباء، كبرتُ وكبُرَ معي هذا الخوف. لم أحاول أن أقتني قطة، كنت أنظر إليها بشوق من بعيد.
نحن أيضا يا كاترين، في ثقافتنا وشرقنا المتخم بالهموم، لدينا رؤية وإشكالات مليئة بالحكايات والمتناقضات والأسرار إزاء هذا الكائنات الأليفة، لكن الغالبية لا تكترث لهم، همومنا لا تتسع لرفاهية هذا الحب، ونحن في سعينا المضني من أجل تحصيل وجود ومكان وحق يليق بنا في هذا العالم، ليس لنا الوقت ولا القلب لنتناغم معهم، رغم أن التعاليم الدينية والكتب المدرسية، تحث وتدعو إلى الرفق بهم. لكن حديثك عن القطط، أطلق أسراباً من الأسئلة في عقلي، قد تبدو لك أو للغير أو حتى لنفسي متناقضة، أعترف بأن هذا التناقض يرافقني كصديق لدود. قد أبرر ذلك وأنا أتوارى خلف ابتسامة خجولة وأتمتم: إنه أزمة العصر الحديث يا صديقتي.
فهل أقول لك جديداً، إذا اعترفت أني أشبه هذا العالم المأزوم، وأنه قدّر لي ولأمثالي ممن فرضت عليهم الظروف، أن يتعثروا بين الـ»هنا» والـ»هناك». أن يعيشوا هذه الازدواجية وهذا القلق. فأنا أحب هذا الكائن اللطيف وأتفق مع رأي الكاتب الإنكليزي ديكنز «لا توجد هدية أعظم من حب قطة» لكنني لا أستطيع أن أمنع نفسي من الدهشة وأنا أرى القطط والكلاب – في هذه البلاد – تزاحم البشر في البيوت والشوارع والحدائق والمطاعم والباصات والقطارات، ويعتصر الهم قلبي عندما أرى شبانا صغارا فقراء – أغلبهم سمر البشرة- وهم ينزهون الكلاب المترفة في الهواء الطلق، مقابل دراهم قليلة، ينتظرونهم بصبر حتى يبولوا، يجمعون برازهم بعناية في كيس أسود صغير، يرمونه في علبة خاصة للكلاب ويمضون. وكيف أمنع نفسي من أن لا أُستفز، وأنا أشاهد هذا الهوس العجيب الذي تتفنن به الدعايات والاختراعات الحديثة، لجعل حياتهم أكثر راحة ورفاهية وأماناً. والمخازن المترفة تمتلئ بطعامهم الصحي، حتى إن هناك مطاعم وفنادق خاصة للكلاب والقطط.
في حين أن الجوع يفتك بالبشر!
هل يمكنني أن لا أرى في هذا كله، كارثة مهولة، ومنفى حقيقيا. وهل يمكنني أن لا أقول إنه عصر مطعون بالقلق، ربما مفردة قلق هي الأسهل، ولها إيقاع التوسط بين المتناقضات. أجد نفسي أتساءل بكثير من الجدية والفضول: «ما الذي يدفع الإنسان – الغربي خصوصا- إلى الهوس بهذا الكائن! هل هو علاج؟ يقال إن القطط تساعد على إفراز هرمون الحب لدى البشر! ربما يتوجب عليّ هنا أن أستعير قليلاً دور المحلل النفسي الذي لا أتقنه، ولا أتقن المفردات الضخمة التي قد تقال في هذا المجال، لكنني أرى ببساطة، أنه في ظل هذا العالم الممسوس بإشكاليات إنسانية معقدة عن الحياة والمتغيرات والبشر. أدرك الفرد فيه كم هو وحيد ومهزوم، أمام عالم يصخب بالعبث والعنف والصراع والحروب. انكفأ بعيدا يمارس فرديته المطلقة. وفي هذه الحالة، لا بد من بعض نداوة وطراوة تخفف عنه الوحدة والتجاهل، وإن علاقة سهلة مع كائن لطيف دون كلفة وألم، يجلس بالقرب منه، بعد نهار طويل ومرهق، يدور حوله ويتمسح به ويموء بصوت شجي، قد يُهدئ من قلقه، ويساعده على الاسترخاء، ويشعر بأنه صديق يبثّه مشاعره، وأنه ليس وحيدا. قلت لي يا كاترين في لقائنا الأخير، وكنا نتحدث عن الكتابة، على أنها فعل حر، بمعنى أن على الكاتب أن يكون صدى روحه وعقله، قلت لي أنت هنا في بلد حر، من حقك الحديث والتفكير والكتابة، دون خوف، فلا تتهاوني في استعمال هذا الحق.
حسنا يا صديقتي، لن أتهاون في استعمال حقي هذا وهأنذا أتساءل: هل أبدو لك غير منصفة وغير حضارية عندما أُدهش وأحتج وأنتقد حادثة قامت فيها الدنيا ولم تقعد، وتصدت لها الأقلام، ورصدت لها البرامج والحوارات والتحاليل المملة، احتجاجاً على تعامل وصف باللاإنساني، لأن أحدهم سافر، وترك كلبه وحيدا يموت من الجوع. هل أبالغ حين أصف هذه الحادثة، على أنها ليست أكثر من مهزلة ساخرة، كوميديا سوداء، لا تدري فيها إن كان عليك أن تبكي أو تضحك، أو حتى تقهقه. فلو أزحتِ البصر قليلا، قليلاً جدا فقط يا كاترين، لرأيتِ بقاعاً في العالم، يعيش فيها بشر دون مأوى، بشر يموتون جوعاً وبرداً، أطفال حقيقيون، وليس حيوانات أليفة، يبادون، تحصدهم الطائرات كالعصافير، والعالم يتوارى ويتفرج ساكناً! ماذا عن الضمير! الضمير الذي أكده جيمس هنري في كتابه «فجر الضمير» «اللحظة التي سمع بها الصياد أول مرة همسا داخله يؤنبه». يبدو أنه ضمير مرن اليوم يا صديقتي، تلك هي المسألة. فهل هناك من معادلة تقي العالم المطعون بحمّى التناقض خطر الانفجار؟
كاتبة سورية